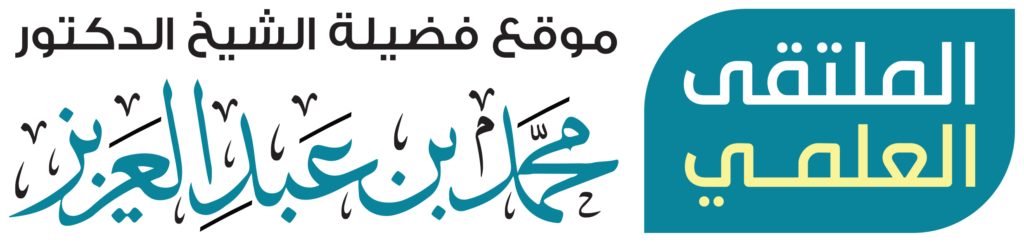الحمد لله الكريم المنان ذي الطول و الفضل والإحسان و الإنعام، الذي هدانا للإيمان، وصلاة وسلامًا على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وبعد:
فإن مما يحتاج إليه قارئ القرآن معرفة أحكام سجدة التلاوة، و سوف نتناول في هذا المقال باختصار خمسة مسائل تتعلق بها، و هي:
المسألة الأولى: تعريف سجدة التلاوة.
المسألة الثانية: مواضع سجدة التلاوة.
المسألة الثالثة: حكم سجدة التلاوة.
المسألة الرابعة: أذكار سجدة التلاوة.
المسألة الخامسة: شروط سجدة التلاوة.
أما المسألة الأولى: تعريف سجدة التلاوة: سجدة التلاوة لها تعريفان: الأول باعتبار مفرديها، و الآخر تعريف لقبي.
أما التعريف باعتبار مفرديها: فكلمة: سجدة: اسم مرة من الفعل سجد، وصيغ على هيئة اسم المرة للدلالة على أن السجود حدث مرة واحدة.
و السجود لغة: الخضوع و التذلل، وسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى.
و السجود اصطلاحًا: وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت مستقر على هيئة مخصوصة.
و التلاوة: مصدر تلا يتلو، وهو بمعنى: الاتباع، يقال: تلوته إذا تبعته، ومنه تلاوة القرآن، لأنه يتبع آية بعد آية.
و”ال “في التلاوة هنا للعهد الذهني، فالمراد: تلاوة الآيات المخصوصة التي يشرع بعدها السجود.
و سجدة التلاوة لقبًا: سجدة ـ واحدة ـ يأتي بها القارئ للقرآن أو المستمع في مواضع مخصوصة، في الصلاة و خارجها.
و سميت بذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه، فكأنه قيل: السجدة التي سببها التلاوة.
المسألة الثانية: مواضع سجدة التلاوة:
اختلف أهل العلم في مواضع سجدات التلاوة في القرآن فأكثر ما قيل عند الجمهور: خمسة عشر سجدة، وقيل: ستة عشر سجدة، تبدأ بآخر سورة الأعراف، و تنتهي بسورة العلق، و اتفقوا من ذلك على عشرة مواضع.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 31): «اتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة.
واتفقوا منها على عشر واختلفوا في: التي في “ص”، وفي الآخرة التي في “الحج”، وفي الثلاث اللواتي في “المفصل”.»
و المواضع العشرة المتفق عليها هي:
1 – سورة الأعراف: وهي آخر آية فيها “. . . {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ}.
2 – سورة الرعد: عند قول الله تعالى: . . . {وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآْصَال} من الآية الخامسة عشر.
3 – سورة النحل عند قول الله تعالى: . . . {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} من الآية الخمسين.
4 – سورة الإسراء: عند قول الله تعالى: . . . {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} من الآية التاسعة بعد المائة.
5 – سورة مريم: عند قول الله تعالى: . . . {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} من الآية الثامنة والخمسين.
6 – سورة الحج: عند قول الله تعالى: . . . {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَل مَا يَشَاءُ} من الآية الثامنة عشر.
7 – سورة النمل: عند قول الله تعالى: . . . {رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} من الآية السابعة والعشرين.
8 – سورة السجدة {الم تنزيل} . . . عند قول الله تعالى: {وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} من الآية الخامسة عشر.
9 – سورة الفرقان: عند قول الله تعالى: . . . {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} من الآية الستين.
10 – سورة فصلت عند قول الله تعالى: … {وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ} من الآية الثامنة والثلاثين.
و أما المواضع الستة المختلف فيها فهي:
1 ـ سجدة الحج الثانية، عند قوله: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]
ودليل السجود فيها حديث عقبة بن عامر قال: «قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في سورة الحج سجدتان؟
قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.» أخرجه أبو داود (1401)، و ابن ماجه (1057)، و قد حسنه النووي و المنذري، و الألباني بشواهده.
و السجود فيها هو قول: عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي موسى رضي الله عنهم، و قد أخرج أحاديثهم الحاكم في المستدرك (2/431)، و البيهقي في السنن (2/317).
وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي العالية وزر بن حبيش، و هو مذهب الشافعية، و الحنابلة.
قال ابن قدامة (1 / 443): «لم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا.
وقال أبو إسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين.
وقال ابن عمر: لو كنت تاركًا إحداهما لتركت الأولى.
وذلك لأن الأولى إخبار، والثانية أمر، واتباع الأمر أولى.»
2 ـ سجدة “ص” عند قوله: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24].
والسجود فيها هو قول عثمان فقد صلى عثمان رضي الله تعالى عنه و قرأ في الصلاة سورة “ص” وسجد وسجد الناس معه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينكر عليه أحد، ولو لم تكن السجدة واجبة لما جاز إدخالها في الصلاة.
محمد عبد العزيز, [08/03/2025 09:52 م]
والسجود فيها هو مذهب الحنفية، و المالكية، و عند الشافعية، و الحنابلة هي سجدة شكر لا تلاوة، فليست من عزائم السجود.
و استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: « “ص” لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا» أخرجه البخاري (1069).
3 ـ سجدة الحجر عند قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 98]، و معنى {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ}: كن من المصلين و لأجل ذلك لم ير الجمهور في هذا المحل السجود، و السجود في هذا الموضع مذهب أبي حذيفة، و يمان بن رئاب خلافًا لجماهير العلماء. [تفسير القرطبي (10 / 63)]
4 ـ سجدة سورة النجم عند قوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62].
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد» أخرجه البخاري (1070).
5 ـ سجدة سورة الانشقاق عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21].
6 ـ سجدة سورة العلق عند قوله: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].
و السجود في الانشقاق و العلق دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}» أخرجه مسلم (578).
و السجود فيها هو مذهب جمهور أهل العلم، و يسجد فيها عند المالكية خروجًا من الخلاف.
[ينظر: التوضيح، لابن الملقن (8 / 384)، و الموسوعة الفقهية الكويتية ملخصًا (24 / 216 و ما بعدها)]
و سجدة التلاوة في هذه المواضع الخمسة عشر يجمعها بالاستقراء ثلاثة أنواع:
النوع الأول: خبر عن أهل السجود من الصالحين ومدح لهم.
النوع الثاني: أمر بالسجود.
النوع الثالث: ذم على ترك السجود.
[ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ـ جمع ابن القاسم ـ (23 / 136)، و شرح مختصر القدوري، للجصاص (1 /730).]
المسألة الثالثة: حكم سجدة التلاوة:
اتفق أهل العلم على مشروعية سجدة التلاوة لأدلة منها:
1 ـ حديث ابن عمر، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ ونحن عنده؛ فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد بعضنا لجبهته موضعا -في غير صلاة-» أخرجه البخاري (1076)، و مسلم (103).
2 ـ حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله – وفي رواية أبي كريب: يا ويلي – أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» أخرجه مسلم (133).
ثم اختلف أهل العلم في نوع الحكم التكليفي لسجدة التلاوة على مذهبين مشهورين:
الأول: القول بالوجوب، و هو مذهب الحنفية، و قد اختاره ابن تيمية، و الوجوب عندهم على التالي، والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد.
و استدلوا بأدلة منها:
1 ـ الأمر بالسجود عند هذه الآيات في نحو قوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، و قوله: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].
2 ـ للذم على ترك السجود في نحو قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21]
[ينظر: مختصر القدوري (ص 38)، و المبسوط، للسرخسي (2 / 4)، و مجموع الفتاوى (23 / 139)]
الثاني: القول بالاستحباب، و هو مذهب الجمهور، و هو الراجح إن شاء الله تعالى، و قد استدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 ـ حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- «أنه قرأ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سورة النجم فلم يسجد فيها ولا أمره بالسجود.» أخرجه البخاري (1072، 1073) ومسلم (577).
2 ـ حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه» وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» أخرجه البخاري (1077)
[الجامع لمسائل المدونة، لابن يونس (2 / 676)، و العزيز شرح الوجيز، للرافعي (2 / 103)، و المغني (1 /446)]
المسألة الرابعة: أذكار سجدة التلاوة:
يقال في سجدة التلاوة ما يقال في سائر الصلاة فمما يقال:
1 ـ سبحان ربي الأعلى، كسائر الصلوات.
2 ـ سَجَدَ وَجْهي للذي خَلَقَه وشَقَّ سَمعَه وبَصَرَه بحوله وقُوَّته.
لحديث عائشة قالت: «كان رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم – يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارًا: سَجَدَ وَجْهي للذي خَلَقَه وشَقَّ سَمعَه وبَصَرَه بحوله وقُوَّته» أخرجه أبو داود (1414)، و الترمذي (587) و (3723)، والنسائي (1129)، و قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
محمد عبد العزيز, [08/03/2025 09:52 م]
3 ـ اللهمَّ اكتب لي بها عندك أجرًا، واجعلها لي عندك ذُخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدِك داود.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك: قال ابن عباس: «فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة، ثم سجد»، فقال ابن عباس: فسمعته وهو «يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة» أخرجه الترمذي (579 )، وابن ماجه (1053 )، و قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (6 / 470 / 2710).
المسألة الخامسة: شروط سجدة التلاوة:
لسجدة التلاوة صورتان:
الأولى: أن تكون في الصلاة فلا خلاف بين أهل العلم أنه يشترط لها ما يشترط للصلاة.
الثانية: أن تكون خارج الصلاة فهذه الصورة اختلف أهل العلم فيها على قولين:
الأول: و هو مذهب الجمهور فيشترطون فيها ما يشترطون في الصلاة من: الطهارة من الحدثين، و طهارة الثياب و المكان، و ستر العورة، و استقبال القبلة، قال في المغني (1 /444): «وجملة ذلك، أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة؛ من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولا نعلم فيه خلافًا، إلا ما روي عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – في الحائض تسمع السجدة، تومئ برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب، قال، ويقول: اللهم لك سجدت.
وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه.»
و قال القاضي عياض في إكمال المعلم (2 /523): «لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة جسد وثوب، ونية، واستقبال قبلة، ووقت مباح للصلاة.»
و مبنى هذا القول على تشبيه السجود بالصلاة فيشترطون فيه ما يشترطونه في الصلاة قياسًا عليها.
القول الآخر: أنه لا يشترط لها شيء من شروط الصلاة؛ لأنه ليست صلاة، و هو مذهب ابن عمر فقد كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ، و قد علقه البخاري بصيغة الجزم، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما «يسجد على غير وضوء»، و قد سبق مذهب عثمان، و ابن المسيب، و هو الأشبه بمذهب البخاري فقد أخرج حديث ابن عمر محتجًا به، و هو مذهب الظاهري، و هذا المذهب أقوى، و مذهب الجمهور أحوط، و الله أعلم.
هذا ما يسره الله في هذا المقام، و الحمد لله رب العالمين.